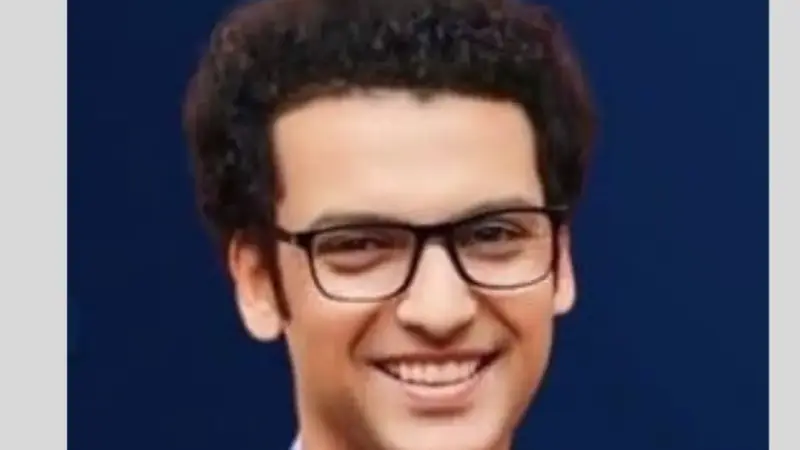
تُمثل الأزمة الاجتماعية إحدى أبرز الظواهر المعقدة التي تميز العصر الحديث، ولا سيما في ظل سيطرة النمط الرأسمالي على البنية الفكرية والمؤسساتية للمجتمع، في هذا السياق يذهب عبد الله أوجلان في كتابه "المدنية الرأسمالية" إلى أن هذه الأزمة ليست مجرد عرض سطحي، بل هي نتيجة حتمية لبنية السلطة والهيمنة التي ترسخت عبر قرون طويلة من التحول الحضاري.
ويشير أوجلان إلى الأزمة الاجتماعية بأنها تُعبر عن المراحل التي يسقط خلالها النظام في حالة يعجز فيها عن الاستمرار بذاته، وهي ذات معنى أعم مما تعنيه كلمة مشكلة أو قضية، فبينما يغلب الطابع الدوري على الأزمات، فإن القضايا تُعاش يومياً في الأحداث والظواهر والعلاقات والمؤسسات، وبينما تُنعت الأزمات التي تُعاش داخل نفس النظام بمصطلح "الأزمات الدورية"، فإن أزمة النظام بذات نفسه توصف بمصطلح "الأزمة البنيوية"، هذا وللأزمات الاجتماعية أسبابها المتعددة، فكيفما أن بعضها ينبع من المجالات السياسية والاقتصادية والديموغرافية، فإن بعضها الآخر مصدره جيوبيولوجي.
وعليه؛ يمكن تعريف الأزمة الاجتماعية من منظور أوجلاني بأنها: "انهيار في المعنى والروابط الاجتماعية ناتج عن هيمنة نمط حضاري سلطوي رأسمالي، يفكك البنى المجتمعية التقليدية، ويحول الإنسان من كائن اجتماعي أخلاقي إلى فرد منعزل، خاضع للاستهلاك ومسلوب الإرادة".

ويطرح تعريف أوجلان لمفهوم "الأزمة الاجتماعية" جوهر الأزمة الرأسمالية في حقيقة الأمر، والمتمثلة في:
1- أزمة في المعنى: يشير إلى جوهر الأزمة ليس مادياً أو اقتصادياً فقط، بل أزمة في "المعنى" ذاته، فالحياة فقدت معناها الحقيقي، وأصبحت محكومة بمنطق الربح والمصلحة، مما أدى إلى تفريغها من القيم الأخلاقية والروحية.
2- اغتراب الإنسان: يعتبر أوجلان أن الإنسان المعاصر في ظل الرأسمالية يعاني من اغتراب شديد عن طبيعته الاجتماعية، فبدلاً من أن يكون فاعلاً في مجتمعه أصبح كائناً معزولاً مستهلكاً ومنفصلاً عن الطبيعة وعن الجماعة.
3- تفكك المجتمع الحديث: يصف أوجلان المجتمع الحديث بأنه مجتمع متفسخ داخلياً، هذا التفسخ نتيجة فقدان القيم الاجتماعية، وهيمنة الدولة القومية، وتسليع القيم الإنسانية، مما أدى إلى شرذمة المجتمع أفراداً متنافسين لا تربطهم سوى علاقات مادية.
4- السلطة كسبب بنيوي: الأزمة ناتجة عن نظام سلطوي متجذر، يتمثل في الدولة القومية والحداثة الرأسمالية، والتي تعمل على السيطرة والتحكم بكل من الإنسان والطبيعة، عبر مؤسسات القانون والعلم والإعلام والدين الممسوخ.
5- الرأسمالية كمرض مجتمعي: يصف أوجلان الرأسمالية بأنها ليست مجرد نظام اقتصادي، بل بمثابة مرض سرطاني اجتماعي، يسري في كل خلايا المجتمع، ويفتت تماسكه، ويحول الإنسان إلى وسيلة للربح وليس غايته الإنسانية بحد ذاتها.
ومن التناول السابق لمفهوم الأزمة الاجتماعية يتضح أن الأزمة الاجتماعية الراهنة هي أزمة ناتجة عن تدمير متواصل للمعنى، وعن اختلال العلاقة بين الإنسان والمجتمع، والإنسان والطبيعة، بفعل تغول النظام الرأسمالي، فيما تتضح مظاهرها في انهيار الروابط الاجتماعية بسبب سطوة الأسلوب العلمي المجرد من الأخلاق، والتفكك المجتمعي الذي نتج عن تحويل الإنسان إلى كائن استهلاكي منغلق على ذاته، وفقدان الحرية وانعدام العدالة بسبب هيمنة الدولة القومية باعتبارها لوياثان عصري - وحش السلطة الحديثة - وهذا يعلل أن الأزمة الاجتماعية الرأسمالية لا تتمثل فقط في جانبها الاقتصادي بل هي أزمة حضارية شاملة، ناتجة عن تغول السلطة الرأسمالية، تفقد الإنسان طبيعته المجتمعية، وتستبدل المعنى بالفراغ، والمجتمع بالأفراد المنعزلين، والحياة بالزيف والتمثيل.
ويتضح في قراءة المفكر عبد الله أوجلان للأزمة الاجتماعية انكشاف الأزمة البنيوية الحضارية المتعلقة بكينونة الإنسان والمجتمع، وليست مجرد مشكلة اقتصادية أو سياسية، وإن اتسمت أطروحات الحلول الأوجلانية بأنها جذرية؛ لكنها تفتح أفقًا حقيقيًا لإعادة بناء الإنسان والمجتمع على أسس الحرية والمعنى والتنوع بعيدًا عن هيمنة المال والسلطة.
وفي حلوله المطروحة يؤكد أوجلان أنها ليست حلولاً تقنية أو اقتصادية فحسب، بل ثقافية وأخلاقية ووجودية، تبدأ من نقد الذات وبناء مجتمع جديد يقوم على الحرية والديمقراطية والمساواة ومعنى الحياة، وأن المخرج من الأزمة الاجتماعية لا يكون إلا بإبداع نمط حياة جديد يؤسس لمجتمع ديمقراطي بيئي نسوي، يعيد الاعتبار للإنسان ككائن اجتماعي أخلاقي.
وعلى هذا الأساس يتميز دور الثقافة بأهمية حياتية في المدنية الرأسمالية، باعتبارها الحصيلة الذهنية لكافة الميادين الاجتماعية، حيث تعمل المدنية الرأسمالية - أولاً - على صهر الثقافة (تكييفها مع السلطة الاقتصادية والسياسية)، ومن ثم تصيرها صناعة في سبيل نقلها على أوسع النطاقات وبكثافة مرتفعة إلى جميع المجموعات (الأمم، الشعوب، الدول القومية، المجتمع المدني، والشركات)، وتشييء الميادين الأساسية، وعلى رأسها الآداب، العلوم، الفلسفات، الحقول الفنية الأخرى، التاريخ، الدين والقانون؛ تكون بذلك قد بضعتها.
وقد طرح عبد الله أوجلان في كتابه "المدنية الرأسمالية" جملة من الحلول الجذرية لمواجهة الأزمة الاجتماعية التي أنتجها النظام الرأسمالي، ضمن رؤية فلسفية وسياسية شاملة سماها بـ"الحضارة الديمقراطية"، وفيما يلي أبرز هذه الحلول:
1- تبني البراديغما الديمقراطية البديلة: يرى أوجلان أن تجاوز الأزمة يستوجب تغييرًا جذريًا في الذهنية والنموذج الحضاري، يطرح ما يسميه بـ"البراديغما الديمقراطية" بديلاً عن الحداثة الرأسمالية، تقوم على الديمقراطية المباشرة والعدالة الاجتماعية وتحرير المرأة والتوازن مع البيئة.
2- تفكيك الدولة القومية كأداة للهيمنة: حيث يصف أوجلان الدولة القومية بأنها "اللوياثان العصري" - وحش السلطة الحديثة - ويقترح تجاوزها عبر الكونفدرالية الديمقراطية، ونقد الهويات القومية المغلقة.
3- إعادة بناء الحياة المجتمعية (الكومينالية/المجتمعية): يدعو أوجلان إلى العودة لشكل المجتمع الطبيعي القائم على التعاون والتشارك وليس التنافس، وإحياء القيم الجماعية الأصيلة.
4- تحرير المرأة كمفتاح لتحرير المجتمع: يعتبر أوجلان قمع المرأة هو النموذج الأول لكل أشكال القمع الأخرى، وأن تحرر المجتمع يبدأ من تحرر المرأة، ويؤكد على تمكين النساء من القيادة ومناهضة التمييز.
5- النقد الجذري للعلموية والوضعية: يرى أن "العلم" في النظام الرأسمالي هو علم مأجور يخدم السلطة، ويدعو إلى علم بديل يقوم على معرفة الذات، ويرفض الفصل بين الذات والموضوع.
6- بناء مؤسسات ديمقراطية قاعدية: يدعو أوجلان إلى استبدال المؤسسات السلطوية بمؤسسات تشاركية مثل المجالس المحلية، الكومونات، والمنصات الشعبية.
7- إعادة الاعتبار للثقافات القديمة والهوية المجتمعية: في هذا الصدد يشدد أوجلان على ضرورة استعادة ثقافة المجتمعات التاريخية في الشرق الأوسط، وتجاوز الاستشراق، والدفاع عن القيم الشرقية الأصيلة.
8- إعادة ربط الإنسان بالطبيعة: يرفض أوجلان الفصل بين الإنسان والطبيعة، ويدعو إلى نمط حياة بيئي مستدام منسجم مع الطبيعة.
وقد استنتج أوجلان في ضوء سياقات هذه الأزمة الإنسانية المطولة وحلولها نتيجة مفادها: "أن ازدياد تعمق المعرفة، والشعور بالحاجة إلى ذلك، وبهذا المعنى؛ فقد تطور العلم والفلسفة بل وحتى الأديان والفنون ارتباطاً بالحاجة الماسة إلى تلبية احتياجات الأزمات الاجتماعية الثقيلة الوطأة".
بذلك يتضح علاقة التأثير والتأثر بين كل من المنهج العلمي والأسلوب الاجتماعي بمختلف أدواره وتكتيكاته في تشكيل السلوك العام للمجتمع في كافة مؤسساته التعليمية والتربوية، حيث تتحدد سماته في تجليات الانعكاسات السلوكية والعادات الاجتماعية والتعاملات بين متنوع أنساقه ونظمه الموجهة علمياً وسياسياً بمختلف علاقاتها الوطنية والأممية.
وعلى إثر هذه العلاقة تتضح فيما أطلق عليه أوجلان "أزمةِ الشخصية" والتي تتضخم في سياقات الهيمنة المتقاطعة في العديد من المجالات، والتي وضح علاقتها أوجلان المتناقضة مع المزاعم الاجتماعية والتربوية والسياسية فيما تناوله: "وعلى النقيض مما يُقال، فإن المواطن الذي يُزعم أنه عصري، والذي لا يتسم بروح المسؤولية أخلاقياً أو سياسياً؛ يمثل أضعف أنواع الفرد خلال العصور، ومن خلال الهيمنة الفيزيائية والأيديولوجية وتطبيقاتها التقنية والمعلوماتية، لم يقتصر المواطن على الاستسلام للنظام الاحتكاري وحسب؛ بل وغدا عضواً فاشياً طوعياً لهذا النظام دون قيد أو شرط".
وينكر أوجلان هذه النتيجة المتشكلة من السيطرة الذهنية الأيديولوجية صنيعة الثقافة المشيأة: "إذ لا يمكن للطبيعة الاجتماعية أن تتكون من نوع هذه الشخصيات، لأن نسيجها الأساسي ذو نوعية أخلاقية وسياسية، إن الدول قادرة على السير بهذه الشخصيات، ولكن ما من مجتمع يمكنه الاستمرار بهذه الشخصية. أو بالأصح؛ فهذه الشخصية تعبير عن تفنيد وإقصاء المجتمع".
وامتداداً لهذه المرحلة أصبح المنظور العلمي في الأوساط الاجتماعية القائمة مضاداً للحقائق بنسبة كبيرة، والسبب في ذلك إنشاء الوعي الخاص تجاه العديد من القضايا الإنسانية التاريخية والاجتماعية، وتبني هذا الوعي والترويج له، وهذا ما يبرز في تبني الدولة القومية براديغما متناقضة مع حقيقة المفاهيم ومعايير مضامينها.
وهذا التناقض بذاته متعلق بالأزمات الناجمة عن السلطة، ويرى أوجلان أنها تُعاش بالتردي المستمر لمعدل الربح.. وعندما يطول أمد الأزمات النابعة من الأوضاع المفصلية والحرجة السائدة أكثر من ذلك، فإنها تتحول إلى أزمة نظامية ممنهجة، وتغدو سيرورة المجتمع أمراً مستحيلاً تحت ظل هذا النظام.
وبإحالة كل من البحث في الدولة وفهم مشكلاتها؛ يشكلان المدخل الرئيس لتحليل وفهم الأزمة الشاملة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تعيشها المجتمعات العربية – مجتمعات الشرق الأوسط - وهي مركزها، وفيها تتجمع عناصرها الأقوى، فبعد أن كانت الدولة لفترة طويلة وسيلة التحول والتغيير وتقديم الخدمات، أصبحت تظهر في العقدين الأخيرين وكأنها العقبة الرئيسية أمام التغيير والتحول من أي نوع كان، وهكذا تحولت، وهي تتحول بسرعة، من فكرة معبئة إلى صنم أو تميمة لا يعبر التعلق المتزايد بأذيالها والمراهنة عليها إلا عن زيادة عدم فاعليتها وعجزها عن تقديم أي إنجاز حقيقي.
بلا شك؛ تتسم القضايا الاجتماعية بطبيعة تشعبية، لا تتوقف فقط كون منبعها التسلط أو الاستغلال، بل ثمة تداخلات أكثر تشابكاً وتعقيداً، إضافة إلى كونها تمثل مشكلة لنسق ما، وقد تكون في ذاتها – المشكلة - حلاً لدى نسق آخر، ويزيد التعقيد تعقيداً أشد حينما يتم تقديم التسلط والقمع حلاً، ويكون ذلك عبارة عن أحد أشكال التسلط وأسلوب من أساليب الاستغلال الأكثر كثافة، فتتشكل المقاومات والتمردات الدائمة والحروب المضادة، فتكون النتيجة الحتمية العيش تحت نير قمع واستغلال احتكارات التسلط التي تعد منبع القضايا بأكثر الأشكال ذلاً وهواناً، وكأن ذلك قدر محتوم.
........ نقلاً عن مجلة الأمة الديمقراطية
..................
المراجع:
- أوجلان، عبد الله (2018): مانيفستو الحضارة الديمقراطية "أزمة المدنية وحل الحضارة الديمقراطية في الشرق الأوسط"، ترجمة: زاخو شيار، المجلد الرابع، ط (3)، مطبعة داتا سكرين، لبنان.
- أوجلان، عبد الله (2018): مانيفستو الحضارة الديمقراطية "المدنية الرأسمالية، العصرانية الديمقراطية وقضايا تجاوز الحداثة الرأسمالية – عصر الآلهة غير المقنعة والملوك الغزاة"، ترجمة: زاخو شيار، المجلد الثالث، ط (3)، مطبعة داتا سكرين، لبنان.
- أوجلان، عبد الله (2018): مانيفستو الحضارة الديمقراطية "سوسيولوجيا الحرية"، ترجمة: زاخو شيار، المجلد الثالث، ط (3)، مطبعة داتا سكرين، لبنان.