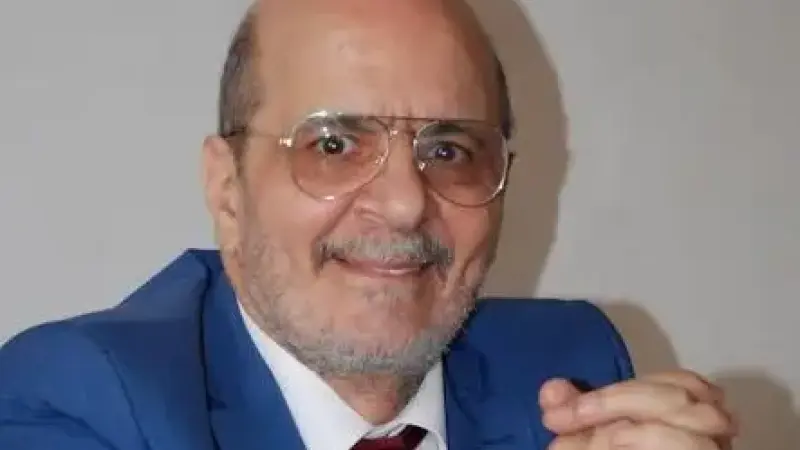
منذ قرنٍ مضى، وخرائطنا تمزّقها الدولة القومية كما لو كانت سكينًا حادة قُدّر لها أن تقطع الأوصال بدل أن توصلها. نشأت على أنقاض الإمبراطورية العثمانية كأنها وعد بالخلاص، لكنها تحوّلت سريعًا إلى قيد جديد؛ قيدٍ يصادر التعدد، ويقصي المختلف، ويزرع بين أبناء الوطن الواحد حدودًا من الخوف والشك.
لم تكن بيتًا جامعًا، بل أسوارًا عالية تحاصر الأقليات، وتفتّت الهويات، وتحوّل الوطن إلى فسيفساء متنافرة. ومن فلسطين الجريحة إلى سوريا الممزقة، ومن لبنان المتصدع إلى السودان المثقل بالجراح، ظل السؤال يتردّد كنداء في صحراء: كيف تبقى الدولة القومية على قيد الحياة وسط كل هذا الانقسام؟
في قلب هذا الظلام، يطلّ فكر عبد الله أوجلان كرؤية تتحدى المستحيل: التكامل والاندماج الديمقراطي مع الدولة القومية. ليس استسلامًا ولا ذوبانًا، بل ولادة جديدة لوطن لا يُقصي أحدًا، بل يعترف بالجميع، ويصوغ عقدًا اجتماعيًا يعيد للإنسان كرامته، وللأمة تنوعها، وللمستقبل أفقًا يليق بالتضحيات.
حين تحدث عبد الله أوجلان عن التكامل والاندماج الديمقراطي مع الدولة القومية، لم يكن يطرح شعارًا طوباويًا، بل مشروعًا لإنقاذ شعوبٍ أنهكتها الحروب والانقسامات. جوهر الفكرة أن العلاقة بين الدولة القومية ومكوّناتها ليست علاقة غالب ومغلوب، ولا صيغة ذوبان يبتلع فيها المركز هوية الأطراف، بل صيغة شراكة واعية تقوم على الاعتراف والحقوق المتبادلة.
التكامل عند أوجلان يعني أن تبقى الدولة إطارًا سياسيًا جامعًا، لكنه ليس قفصًا. أن تتحول من أداة للإقصاء إلى مساحة لاحتضان التعدد. أن تكون الهوية القومية الكبرى سقفًا يحمي، لا سيفًا يقطع. أما الاندماج الديمقراطي، فهو العملية التي تجعل كل مكوّن يشعر أنه شريك في صياغة القرار، لا مجرد تابع أو ضيف عابر.
بهذا المعنى، لا تعود الدولة القومية خصمًا للهويات الكردية أو العربية أو السريانية أو غيرها، بل تتحول إلى فضاء أرحب تتعايش فيه جميعها، حيث تُصان الخصوصيات، وتُبنى الوحدة على أساس العدالة لا على منطق الغلبة. إنها دعوة لتجاوز منطق الإلغاء إلى منطق التكامل، ولتحويل التاريخ من سجل صراعات إلى سجل تعايش.
قد يظن البعض أن أطروحة التكامل والاندماج الديمقراطي تخص الشعب الكردي وحده، بوصفه الأكثر اصطدامًا بجدران الدولة القومية. غير أن قراءة متأنية لفكر عبد الله أوجلان تكشف أن المسألة أبعد بكثير: إنها رؤية لمعالجة أزمة الشرق الأوسط برمّتها.
فالمعضلة في فلسطين ليست فقط احتلالًا عسكريًا، بل أيضًا إنكارًا لحق شعب في تقرير مصيره داخل منظومة إقليمية تفتقر إلى التكامل. وفي سوريا، تتجلى مأساة الدولة القومية حين تُصرّ على النموذج الأحادي وتتنكر لتعدد الهويات داخلها. وفي لبنان، نرى هشاشة الدولة عندما تُبنى على المحاصصة لا على عقد اجتماعي جامع. أما السودان، فقصته المريرة تكشف كيف يمكن للإقصاء أن يتحول إلى حروب أهلية وانفصال.
كل هذه الأمثلة تؤكد أن الأزمة واحدة، وإن اختلفت تجلياتها: دولة قومية عاجزة عن استيعاب التعدد. وهنا تبرز قيمة ما طرحه أوجلان: أن الطريق للخروج من المأزق لا يمر عبر تفكيك الدول أو إنكارها، بل عبر إعادة تعريفها لتصبح دولة مواطنة تتسع للهويات كافة. إن تكامل المكوّنات واندماجها ديمقراطيًا داخل الدولة هو الشرط الضروري لتجديد شرعيتها وضمان بقائها.
حين يتحدث أوجلان عن الأمة الديمقراطية، فإنه لا يطرح بديلًا رومانسيًا للدولة القومية، بل يسعى إلى إعادة تعريف مفهوم الانتماء نفسه. فالأمة الديمقراطية ليست حدودًا جغرافية مرسومة، ولا هوية قومية مغلقة، بل شبكة من العلاقات المجتمعية تقوم على الاعتراف المتبادل، والمساواة، والقدرة على إدارة الاختلاف.
بهذا المعنى، لا تُبنى الأمة الديمقراطية على الإقصاء أو الانصهار القسري، بل على قاعدة أن التنوع ليس تهديدًا بل مصدر قوة. يمكن أن يكون العربي والكردي والسرياني والأرمني جزءًا من نسيج واحد، دون أن يتنازل أي منهم عن خصوصيته. الدولة هنا تتحول إلى إطار إداري يخدم المجتمع، لا سلطة فوقية تحتكره فئة واحدة.
هذه الرؤية لا تلغي الدولة القومية بالمعنى السياسي، لكنها تفرغها من نزعتها الاحتكارية، وتضعها في حجمها الطبيعي كأداة لتنظيم الحياة المشتركة. ومن هنا، تصبح الأمة الديمقراطية أفقًا لحل أزمات الشرق الأوسط: تجاوز الطائفية في لبنان، إنهاء الإقصاء في سوريا والعراق، إعادة الاعتبار للتعدد في السودان، وتعزيز وحدة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال.
إنها ببساطة، محاولة لإعادة تعريف معنى الانتماء: من الانتماء القسري إلى الانتماء الطوعي، ومن دولة الجدران إلى دولة الجسور.
لقد آن الأوان أن ندرك أن أزماتنا لم تكن قدرًا محتومًا، بل كانت نتاجًا لدولة قومية وُلدت مبتورة، عاجزة عن استيعاب شعوبها. قرن كامل مضى ونحن ندور في الحلقة نفسها: إقصاء يولّد تمردًا، وتمرد يجرّ قمعًا، وقمع يفتح أبواب الانقسام والحروب.
إن رؤية التكامل والاندماج الديمقراطي، وفكرة الأمة الديمقراطية، ليست ترفًا فكريًا ولا مشروعًا محليًا، بل طريق خلاص للأمة كلها. إنها دعوة إلى أن نعيد صياغة عقدنا الاجتماعي على أسس الاعتراف والعدالة، بدل الإلغاء والقسر.
قد يُغيَّب القادة في السجون، وقد تُشوَّه الأفكار في أروقة السياسة، لكن الشعوب تعرف طريقها حين تملك الأمل. واليوم، يطل هذا الأمل في صورة مشروع لا يلغي أحدًا ولا يفرض على أحد هوية قسرية، بل يفتح أمامنا أفقًا جديدًا للحرية والعيش المشترك.
فلنستمع إلى هذا النداء، لا بوصفه صرخة كردية فحسب، بل كصرخة عربية–شرقية شاملة.. صرخة تقول: لن تُبنى أوطاننا على الخراب، بل على التكامل. لن نحيا بالانقسام، بل بالاندماج. ولن يكون المستقبل إلا ديمقراطيًا أو لا يكون.
... نقلاً عن بوابة فيتو
منبر الرأي
منبر الرأي