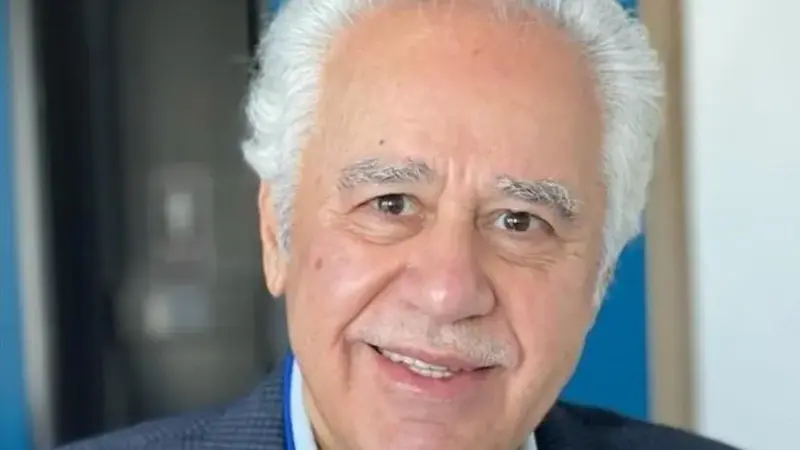
أثارت فضيحة جزيرة إبستين (اسمها الأصلي ليتل سانت جيمس، وهي إحدى الجزر الأمريكية العذراء في البحر الكاريبي)، تداعيات كثيرة بخصوص دور القوّة الناعمة في الإطاحة بزعماء كبار واستدراج شخصيات مشهورة والإيقاع بجهات رسمية وغير رسمية. وكشفت الصحافة الاستقصائية العديد من الخفايا والخبايا والفضائح التي تزكّم الأنوف. والأمر لا يتعلّق بخوارق شخصية سوبرمانية مخابراتية شيطانية مثل جيفري إبستين، بل إن الأمر مدعاة للتساؤل: من يقف خلفه؟ وما هي أهدافه؟ وكيف تمكّن من الوصول إلى مبتغاه؟ ولماذا لم يتم كشف أسراره إلى اليوم؟ فالرجل توفّي في ظروف غامضة في سجنه العام 2019، ثم ماذا يعني نشر وتسريب هذه الوثائق في هذا الوقت بالذات؟ ومن تخدم؟ ومن هي الجهات المتضرّرة والمستفيدة منها، سواءً كانت شخصيات عامة أم جهات رسمية؟
لعلّ ما حصل من كوموتراجيديا، خلال الأسابيع المنصرمة، أعادني إلى دور القوّة الناعمة في الصراع الأيديولوجي بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، وخصوصًا خلال فترة الحرب الباردة (1946 – 1989)، وكيف استُخدمت لإسقاط منظومة أيديولوجية وأحزاب عريقة ومناضلين كبار، كان يشار إليهم بالبنان، سواء في الدول الاشتراكية أو في الدول النامية دون الدخول في حرب عسكرية ذات أكلاف فلكية.
كنت قد نشرت كتابًا في العام 1985 بعنوان "الصراع الأيديولوجي في العلاقات الدولية" (دار الحوار، اللّاذقية)، تناولت فيه أساليب الدعاية السوداء ووسائلها، إضافة إلى دور المعاهد ومراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة في التأثير على العقول وكسب القلوب، في معركة ضارية، علنية وسريّة، استُستخدم فيها جميع الوسائل، من أكثرها شرعيّةً إلى أشدّها لا إنسانية، وخصّصت فقرة كاملة لممارسات إسرائيل العنصرية وأجهزتها الدعائية والأمنية وحربها النفسية.
منذ قيامها في العام 1947، أولت وكالة الاستخبارات المركزية CIA اهتمامات كبيرة بالثقافة، وعملت على جعلها وسيلة وأداة في الدعاية والصراع الأيديولوجي، وخصّصت لها موارد ضخمة وبرامج سريّة واسعة ومتنوّعة، ليس ضدّ المعسكر الآخر كجزء من أذرع الحرب الباردة، بل لاستقطاب كفاءات وشخصيات يسارية من الدول الغربية، وسعت للاستثمار فيها كرأسمال أساسي، فضلًا عن النُخب كرأسمال بشري يمتلك طاقةً هائلة للتأثير، لذلك أصبحت الحرب الثقافية جزءًا لا يتجزّأ من الصراع الدولي، ولا تقلّ ثقلًا عن السلاح النووي أو الكيميائي، وليست أقل أهمية من الصواريخ، ووسائلها ناعمة وأدواتها ماكرة وأساليبها مشوّقة ومغرياتها تبدو بريئة.
ثمة سؤال قديم بقيت أستعيده بين الحين والآخر، وهو ما ورد على لسان الشاعر الأمريكي كارل ساندبيرغ في ستينيات القرن المنصرم: أيهما أكثر تأثيرًا في سياسة الولايات المتحدة، هل جامعة هارفارد أم سينما هوليوود؟ وكان جوابه مثيرًا: هارفرد أنظف من هوليوود، لكن هوليوود أكثر تأثيرًا من هارفارد في الوصول إلى أمد بعيد.
وفي ذلك أكثر من مغزى ودليل على دور القوّة الثقافية الناعمة وأدواتها المختلفة في نشر القيم وطريقة الحياة وفي التأثير على الآخر، وإذا كانت جامعة هارفرد صرحًا علميًا كبيرًا مؤثرًا بلا أدنى شك، إلّا أنها أقل تأثيرًا من هوليوود في نشر القيم الأمريكية، وذلك يعود إلى إنتاجها يصل إلى جمهرة واسعة وعريضة من البشر، خصوصًا وأن ما يحدثه الفن السابع يكاد يهيمن على القلوب والعقول معًا، في حين أن المنتوج الأكاديمي يبقى محصورًا بنخبة محدودة وخاصة، لذلك سعى جهاز الاستخبارات الأمريكي إلى استخدام الفنون والآداب في صراعه الأيديولوجي ودعايته.
كان "مؤتمر حريّة الثقافة" الأمريكي، إحدى واجهات العمليات الثقافية، يموّل مجلّات أدبية وفكرية، ويقيم معارض فنية وفعاليات موسيقية ومؤتمرات ثقافية تحت زعم الحريّة والإبداع في مواجهة ما يُطلق عليه "الواقعية الاشتراكية"، التي كانت اليافطة المرفوعة من جانب المدرسة السوفيتية فيما يتعلّق بالأدب، ليس هذا فحسب، بل إن وسائل الدعاية والتضليل امتدّت إلى الدين وإلى العاملين في الحقل الديني أيضًا لما فيه من تأثير، ففي العام 1954، انعقد في مصيف بحمدون (لبنان) مؤتمر بدعوة من جمعية أصدقاء الشرق الأوسط الأمريكية وبتنظيم غير مباشر من CIA وتمويلها، كما اتّضح لاحقًا، تحت عنوان مكافحة الأفكار المادية الإلحادية، شارك فيه رجال دين من مختلف الطوائف والأديان، وإن كانت ثمة ارتيابات بعضها جاء على لسان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الذي كتب ردًّا على دعوته لحضور المؤتمر بعنوان "المُثل العُليا في الإسلام لا في بحمدون"، وقام الحزب الشيوعي العراقي حينها بطبع مداخلته ووزعها ضمن أدبياته السريّة لفضح توجّه الأجهزة الثقافية الأمريكية المموّلة من جهاز المخابرات المركزية، لكن للأسف أخذت الحدود تُمحى والممانعات تُلغى والتحفّظات تتبخّر، بل ثمة سباقات وهرولات نحو المعسكر الرابح، بعد انهيار الكتلة الاشتراكية، بغض النظر عن أخطاء وخطايا المعسكر الخاسر.
وقد انكشفت بعض تأثيرات وسائل الصراع الناعمة لاحقاً لشراء ذمم مثقفين وكتّاب وإعلاميين، تلك التي اتّخذت في وقت لاحق توقيع عقود مع البنتاغون ومؤسسات وأجهزة أمريكية بصفة خبراء أو استشاريين، وذلك عشية احتلال العراق وتدمير الدولة العراقية (2003)، وعلى هذا المنوال سار عدد من المثقفين من بلدان عربية وأفريقية وأمريكية لاتينية.
وحتى قبل انهيار أنظمة أوروبا الشرقية التوتاليتارية انخرط في هذه الأنشطة مثقفون كبار، بعضهم على علم ودراية بمن يقف خلفها ومن يموّلها، والبعض الآخر برّر مشاركته لأنه يريد نشر وجهات نظره المخالفة، طالما توفّرت الفرصة للتعبير عنها ضدّ ما هو سائد من تيار اشتراكي وشيوعي رسمي، وهو ما شجّعت عليه السياسة الخارجية الأمريكية، تحت عناوين برّاقة مثل "الحريّة الأكاديمية" و"حريّة التعبير"، وهو ما يرد تفصيلاته في كتاب ف. س. سوندرز "من يدفع للزمّار؟ الحرب الباردة الثقافية" (ترجمة طلعت الشايب وتقديم عاصم الدسوقي، القاهرة، 2009).
واستُخدمت في الحرب الثقافية مؤسسات خيرية عديدة أمريكية وأوروبية بعضها ما زال عاملًا نشيطًا، وخصوصًا منذ مطلع التسعينيات وحتى مع بدايات ما أُطلق عليه "الربيع العربي" (2011) لتمويل عدد من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، بزعم أن مصادر تمويل هذه الجهات معفيّة من الضرائب، وبعض هذه المنظمات تعيش إلى الآن على فتات دعم المؤسسات الدولية، ولو توقّفت هذه عن تقديم التمويل السنوي لها لتوقفت هي الأخرى عن العمل، كما حصل مع العديد من المنظمات، لاسيّما بعد أن استنفذت أغراضها.
وتطرح مؤلفة الكتاب سوندرز سؤال الأخلاق، وهو سؤال شك وليس سؤال يقين، مثلما هو سؤال قلق وليس سؤال طمأنينة، أي كيف يمكن أن يكون المثقّف حرًّا إذا كان من يموّله جهاز استخبارات أجنبية لأجندات سياسية؟ وهو سؤال ما يزال مطروحًا، فقد اعتمدت العديد من المنظمات ومراكز الأبحاث على تمويلات غامضة من جهات غريبة، بل إن بعضها تمّ تأسيسه لهذا الغرض، وظلّ يعلّق يافطة اليسار فوق رأسه، وإن كانت روحه مطفأة ورؤيته قاتمة، وحتى وإن فقد دوره وموقعه وقيمته الفكرية، لكنه استُبقيَ كجزء من الجنود في المعركة.
ويقول بول بريمر في كتابه "عام قضيته في العراق" الصادر عن دار الكتاب العربي في بيروت في العام 2006، أنه أنفق 880 مليون دولار على مؤسسات وشخصيات صحافية ومدنية وحقوقية في العراق خلال العام الذي تولّى فيه إدارة الحكم (13 أيار / مايو 2003 – 28 حزيران / يونيو 2004).
كانت الفكرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة في الصراع الأيديولوجي ضدّ العدو الاشتراكي، أن العالم بحاجة إلى عصر تنوير جديد وسلام أمريكي وقرن أمريكي. وحسب هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، أن الهدف هو تحصين العالم ضدّ وباء الشيوعية وتمهيد الطريق أمام مصالح الولايات المتحدة.
وبعد سقوط جدار برلين (9 تشرين الثاني / نوفمبر 1989)، انكشفت هشاشة أنظمة أوروبا الشرقية، بالرغم من أنها كانت تبدو حصونًا منيعةً عالية من الخارج لا يمكن اقتحامها، لكنها كانت خاوية ورخوة من الداخل، حسب المفكّر الفرنسي جان بول سارتر، بفعل الدعاية الطويلة الأمد ووسائلها المؤثّرة وقواها الناعمة، كما انكشف معها جوانب من الفساد والبيروقراطية والتسلّط والاستبداد، فضلًا عن الاختراقات الأمنية والثقافية الكبيرة.
وإذا كان في موت الضمير إجابة على سؤال الأخلاق والقيم الإنسانية، فإن ما هو خاف حتى الآن: كيف تمكّن شخص واحد (بدأ حياته العملية مدرسًا، 1976) من امتلاك إمكانات غير محدودة وحصانات متعدّدة، وحصل على الدعم الخفي والعلني وتصرّف دون حسيب أو رقيب، فأوقع في فخاخه المئات من الشخصيات المعروفة وكبار المسؤولين، إن لم يكن قد حصل على دعم أصحاب السلطة والنفوذ والمال والأجهزة الأمنية؟
نشرت في جريدة الوطن الجديد في 17 شباط / فبراير 2026.