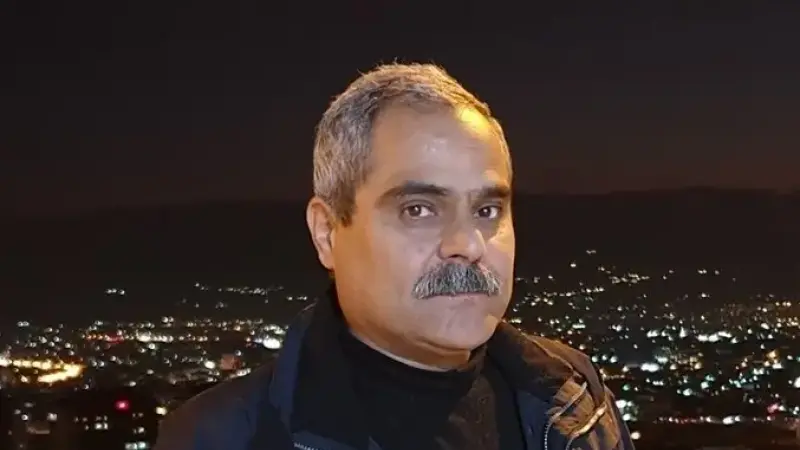
لا يمكن قراءة المشهد التركي الراهن بمعزل عن جذوره العميقة الممتدة لأكثر من قرن. إن الدولة التي قامت على أنقاض “الرجل المريض” عبر هندسة معقدة تداخل فيها النفوذ المالي اليهودي مع الطموح القومي الطوراني، تجد نفسها اليوم أمام ذات المعضلة الوجودية. نحن أمام لحظة تاريخية فارقة تشبه إلى حد التطابق مرحلة الأفول العثماني؛ حيث تلتقي الأزمات الاقتصادية الخانقة مع انسداد الأفق السياسي، وتتحول “القضية الكردية” من ملف أمني داخلي إلى مفتاح البقاء أو الفناء للخارطة التركية.
تشير قراءات تاريخية معمقة لا يلتفت إليها الكثيرون، إلى أن سقوط الخلافة العثمانية لم يكن مجرد حدث عسكري، بل كان عملية “إفلاس سياسي” ممنهجة. لقد شكلت الديون العثمانية “حصان طروادة” الذي امتطته الحركة الصهيونية العالمية.
بينما يخلد التاريخ الرفض العلني للسلطان عبد الحميد الثاني لبيع فلسطين، فإن الوثائق والتحليلات النقدية تشير إلى أن الضغوط الاقتصادية الهائلة وتغلغل النفوذ اليهودي في مفاصل الاقتصاد العثماني قد أوجد واقعاً مغايراً على الأرض، تمهيداً للمشروع الأكبر.
لم تكن “تركيا الفتاة” وجمعية “الاتحاد والترقي” سوى واجهات سياسية لنخبة من يهود “الدونمة” (الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية) ومركزهم سالونيك. لقد لعب هؤلاء، وعلى رأسهم مصطفى كمال أتاتورك -وفق العديد من المصادر التاريخية- الدور المحوري في علمنة الدولة وفصلها عن محيطها الإسلامي، لتصبح “حارساً وظيفياً” للمصالح الغربية، ولاحقاً حليفاً استراتيجياً لإسرائيل في المنطقة.
بعد مرور قرن، يعتلي رجب طيب أردوغان سدة الحكم مستحضراً إرث السلاطين، لكنه في الواقع يعيد إنتاج نفس “الدور الوظيفي” بأسلوب أكثر تعقيداً. حيث يتقن أردوغان لعبة “دغدغة العواطف” للشعوب الإسلامية عبر لعن إسرائيل في العلن، بينما تشير لغة الأرقام والاستخبارات إلى أن التعاون التجاري والعسكري والاستخباري بين أنقرة وتل أبيب يسير في أعمق مستوياته خلف الكواليس. تركيا لا تزال الممر الآمن للطاقة والبضائع نحو إسرائيل، والعين التي ترقب التحركات في المنطقة لصالح الناتو.
كما تأسست الجمهورية الأولى (الكمالية) على دماء الأرمن والسريان والكرد، تحاول “الجمهورية الثانية” (الأردوغانية) تثبيت أركانها عبر التهديد بإبادة الوجود القومي للكرد والعرب في شمال سوريا والعراق. إن تهديدات أردوغان بـ “الدفن” ليست زلة لسان، بل عقيدة سياسية ترى في التطهير العرقي وسيلة وحيدة للحفاظ على وحدة الجغرافيا المصطنعة.
التاريخ يعيد نفسه بصورة تراجيدية. في بدايات القرن العشرين، أدرك أتاتورك استحالة تأسيس تركيا دون الكرد، فتحالف معهم تحت راية “الأخوة الإسلامية” حتى تم له الأمر، ثم انقلب عليهم بالحديد والنار. اليوم، يدرك أردوغان أن تركيا “تتآكل”، فيسعى لتكرار خدعة أتاتورك عبر التودد للقائد عبد الله أوجلان والتلويح بالسلام. لكن الفارق الجوهري يكمن في الوعي السياسي الكردي الراهن.
طرح الزعيم الكردي عبد الله أوجلان رؤية استراتيجية تتجاوز المناورات التكتيكية؛ ملخصها أن “الدولة القومية الأحادية انتهت”. تركيا أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما التحول الديمقراطي والاتحاد مع الكرد، وهو ما يمنح تركيا القوة والمناعة، أو استمرار الحرب والإنكار، وهو الطريق السريع نحو التقسيم والانهيار الداخلي، خاصة وأن الأدوات الأمنية القديمة لم تعد تجدي نفعاً في شرق أوسط جديد يعاد رسمه.
لم تعد إسرائيل ترى في تركيا ذلك الحليف الذي لا غنى عنه، بل باتت تراها أحياناً “منافساً مشاغباً” يجب تحجيمه. القصف الإسرائيلي المتكرر لمواقع سعت تركيا للتموضع فيها (مثل مطار “تي فور” ومطار حماة العسكري ووزارة الدفاع) هو رسالة واضحة من تل أبيب، مفادها “ممنوع التمدد”.
وكذلك منع على تركيا الانضمام لمنتدى غاز المتوسط وكذلك أن تكون ضمن قوة السلام والاستقرار في غزة. فلم تعد تركيا تلك الدولة المحبوبة كما كانت في القرن العشرين. الآن كافة الاصطفافات والتوازنات قد تغيرت، والكثير مما كان مستوراً بات مكشوفاً ولم تعد ثمة معلومات سرية حول الدور الوظيفي لأردوغان في المنطقة ورعايته للإرهاب. حيث باتت إسرائيل ترسم خطوطاً حمراء لطموحات “السلطان الجديد”، وتؤكد أن الهيمنة في المنطقة لا تقبل القسمة على اثنين.
مع صعود محاور جديدة للتطبيع العربي-الإسرائيلي، فقدت تركيا ميزتها الحصرية كجسر وحيد لإسرائيل نحو المنطقة. هذا التهميش الاستراتيجي يجعل تركيا أكثر هشاشة وعرضة للضغوط الدولية التي قد تدفع نحو تقسيمها إذا ما تعارضت مصالحها مع الرؤية الأمريكية-الإسرائيلية للمنطقة.
إن تركيا اليوم ليست دولة صاعدة كما يروج إعلامها، بل هي دولة تعيش “سكرات ما قبل التحول الجذري”. إن الإصرار (التعنت) على الحل الأمني للقضية الكردية، ورفض مبادرات السلام الحقيقية (مشروع الأمة الديمقراطية)، واللعب المزدوج مع القوى الكبرى، كلها عوامل تسرع من سيناريو التفكك.
وكما رسمت اتفاقية “سايكس بيكو” حدود المنطقة قبل قرن، يبدو أن خرائط جديدة تُطبخ الآن في الغرف السوداء. وإذا لم تلتقط أنقرة طوق النجاة الذي طرحه أوجلان (السلام والديمقراطية الحقيقية)، فإن القوى التي ساهمت في تشكيل تركيا قبل قرن، لن تتردد في تفكيكها اليوم لخدمة مصالحها الجديدة. لقد أفل نجم “الدور الوظيفي”، وبزغ نجم “إعادة الهيكلة”، وقد تكون تركيا هي الضحية القادمة على مذبح الشرق الأوسط الجديد.
نقلا عن موقع روج نيوز..