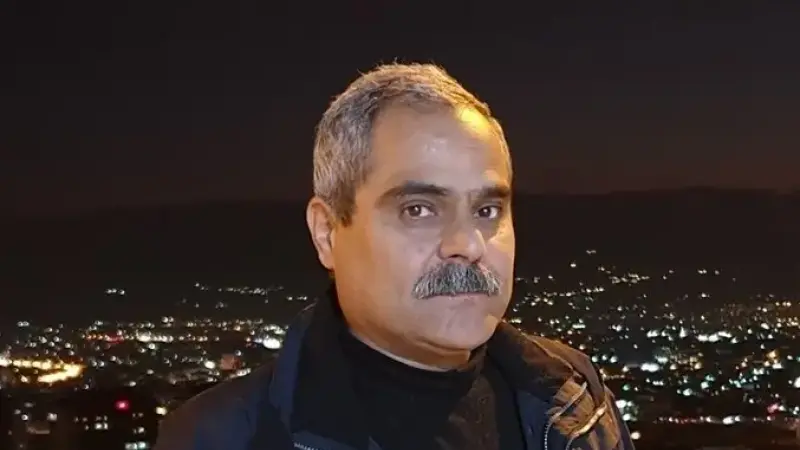
في الذكرى السابعة والاربعون لتأسيس وحلّ حزب العمال الكردستاني، يمكن قراءة أفكار السيد أوجلان من أين بدأت وإلى أين وصلت؟ ولماذا كان اختيار الانتقال للديمقراطية المجتمعية؟ هذه القراءة لا بدَّ منها لمعرفة هذا التحول الذي طرأ في البنية الفكرية للعمال الكردستاني وكيف أن هذا التحول، أثبت أنه على الحركات الثورية ألا تبقى أسيرة أدواتها في درب الحرية. فما قام به السيد أوجلان يمكن وصفها بـ “بيروسترويكا” بكل معنى الكلمة، ولكنها خرجت من عنق زجاجة الحداثة الرأسمالية، ولتدخل فضاء الحداثة الديمقراطية من أوسع أبوابها.
حيث منذ تقسيم جغرافية كردستان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتشتيتها بين أربعة دول قومجية وثيوقراطية والتي من خلالها تم دفن الحقيقة والواقع الكردي، مثلما تم وصفه في السرديات التركية، من بعدها تحولت إلى مجرد “حلم الشعراء”، كما وصفها الراحل مام جلال. ومنذ بداية سبعينيات القرن المنصرم ظهرت مجموعة ممن أُطلق عليهم أسم “الطلبة” كمجموعة بدئية حاولت تعريف اليسار بقضية شعب تم دفنها، من أجل بعثها من جديد. حيث لم تبق أية حقيقةٍ معروفة باسم كرد أو كردستان وكحركةٍ تشكلت على هذا الميراث كانت ولادة حزب العمال الكردستاني كحركة معاصرة، كان أهم نجاحاتها هو إبراز هذه الحقيقة وإحياؤها مرةً أخرى، فقد استطاع العمال الكردستاني إثبات وجود كردستان كواقع، كما جعلها صامدة ولا تُقهر. المقاومة العظيمة للعمال الكردستاني حققت الاستمرارية لوجود الكرد وكردستان وقامت بتطوير وعيٍ قوي بالوجود الكردي. فمن مقولة “كردستان مستعمرة”، هذه الكلمات لم تفتح المجال أمام المقاومة العملية فقط، بل تحولت إلى تحليلٍ تاريخيٍ عظيم، كل هذه الأمور أدت إلى بروز الحقيقة الكردية وهدفت إلى تحقيق التنوير بين الشعب الكردي.
السؤال المطروح هل تم حل قضية الحرية بالنسبة للكرد؟ الجواب وبكل تأكيد كلا. ولكنه لقد تم إثبات الوجود الكردي، الذي وصل إلى مرحلة متطورة من الوعي الفكري والإيديولوجي والتنظيمي. ومنذ بداية تشكيل العمال الكردستاني الذي تأثر بشكل كبير بالاشتراكية المشيدة التي استطاعت في القرن العشرين الوصول إلى سلطة الدولة في كثير من أنحاء العالم، وباتت تهيمن على ثلث العالم ولكن رغم ذلك لم تستطع الصمود، وتعرضت للانهيار. فقد انهارت الاشتراكية المشيدة، بينما بقي العمال الكردستاني صامداً. ولكن الصمود لوحده لم يكن كافياً للوصول للحرية وتحقيق تطلعات وأهداف شعب للعيش في وطن. فمصطلحات ومفاهيم الاشتراكية لم تعد كافية لإحراز النصر في النضال التحرري. فكان لا بدّ من إعادة التفكير مجدداً في آلية النضال والمصطلحات، لإعطاء قفزة نوعية في مسيرة الحرية وبنفس الوقت التخلص من أعباء مصطلحات الاستقلال والسيادة وبناء الدولة القومية. فكان مصطلح “الأمة الديمقراطية”، الذي تطور بناءً على الاشتراكية، وباتت نتيجةً استراتيجيةً بالنسبة للسائرين في درب المقاومة.
ينبغي الاعتراف بأن العمال الكردستاني كان حركة أبرزت واقع وجود كردستان وأوصلت هذا الوجود إلى درجة غير قابلة للهزيمة، طيلة نضال كفاح مسلح على مدار أكثر من أربعة عقود. أما الخطوة التالية التي كانت بعد نداء السيد أوجلان في 27 من شباط 2025، والتي بدأت تحت اسم “مبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي”، فهيمن أجل تحقيق الحرية. والمجتمع الحر الذي سيتشكل على مسار الأخلاق السياسية التي هي أساس الكومونالية، وفق رؤية السيد أوجلان.
حيث أراد السيد أوجلان انتشال العمال الكردستاني من مأزق الماركسية الكلاسيكية ودوغمائيتها المفاهيمية، والانتقال به نحو هيكلية جديدة بنفس العنفوان ولنفس الهدف في الحرية والمجتمع الديمقراطي. حيث قدّم السيد أوجلان (خاصة في مرافعاته وكتبه المتأخرة مثل “مانيفستو الحضارة الديمقراطية”)، نقداً جذرياً للماركسية الكلاسيكية، وتحديداً لفكرة “الحتمية الاقتصادية” والمركزية الطبقية. وحتى أنه يمكننا تلخيص نقد أوجلان لماركس في أن “السلطة تسبق الاقتصاد” وأن “الهرمية تسبق الطبقية”. حيث عمل أوجلان على نقد “اقتصادوية” ماركس. حيث عنده الاقتصاد (البنية التحتية) هو الأساس الذي يحدد شكل السياسة والثقافة والدولة (البنية الفوقية). أي أن من يملك وسائل الإنتاج يملك السلطة. بينما عمل السيد أوجلان على نقد هذه النظرة القاصرة والمادية المبتذلة. حيث بالنسبة لأوجلان، “السلطة والهيمنة السياسية هي التي تخلق الاحتكار الاقتصادي” وليس العكس. الرأسمالية ليست مجرد نظام اقتصادي للربح، بل هي نظام “سلطة” تطور عبر التاريخ لنهب المجتمع. والمشكلة ليست فقط في “فائض القيمة” الاقتصادي (كما قال ماركس)، بل في “فائض السلطة” كما يقرّ السيد أوجلان. وكذلك أن تاريخ المجتمعات عند ماركس هو تاريخ الصراع بين الطبقات (عبد وسيد، إقطاعي وقن، برجوازي وبروليتاري). بينما يرى السيد أوجلان أن اختزال التاريخ في الصراع الطبقي هو “إسقاط” لواقع القرن التاسع عشر الأوروبي على كل التاريخ البشري. بدلاً من ذلك، يرى أوجلان أن الصراع الحقيقي والتاريخي هو بين “الحضارة الدولتية” والمتمثلة بـ (الدولة، السلطة، الاحتكار، الهرمية)، وبين “الحضارة الديمقراطية” المتمثلة بـ (المجتمع الطبيعي، الكومونات، القيم الأخلاقية، حرية المرأة).
كذلك يرى السيد أوجلان أن “الطبقة” مفهوم ضيق، لأن الهيمنة بدأت قبل الطبقات الاقتصادية (بدأت بهيمنة الرجل على المرأة في العائلة، ثم الكاهن على المجتمع، ثم الدولة على الشعب). والنقطة الثالثة الهامة هي أن ماركس كان يرى أن الدولة هي أداة بيد الطبقة المسيطرة (أي أن الطبقة تظهر أولاً ثم تخلق الدولة لتحمي مصالحها)، بينما السيد أوجلان يقلب الآية تماماً. حيث يرى أن “الدولة هي التي خلقت الطبقات”. جهاز الدولة (منذ السومريين والزيغورات) هو الذي نظم عملية النهب والاستعباد وخلق طبقة تملك وطبقة لا تملك. لذلك، لا يمكن الوصول للحرية عبر “دولة العمال أو البروليتاريا” (كما أراد الماركسيون)، لأن الدولة بحد ذاتها أداة قمع واستعباد ولا يمكن أن تكون وسيلة للتحرر.
السيد أوجلان لا ينسف ماركس بالكامل، بل يعتبره عظيماً لكنه وقع في فخ “المركزية الأوروبية” و”الدولتيّة“. والسيد أوجلان يحاول تجاوز ماركس عبر استبدال “الاشتراكية العلمية” (التي تركز على الاقتصاد والدولة) بـ “الاشتراكية الديمقراطية”، التي تركز على البيئة، حرية المرأة (التي يعتبرها أوجلان أول طبقة مستعبدة في التاريخ)، والمجتمع الأخلاقي والسياسي بعيداً عن سيطرة الدولة.
وبين التأسيس والحلّ كانت أكثر من أربعة عقود مليئة بالمقاومات التي تحولت لدروس وعبر للكثير من شعوب العالم وكذلك للعدو قبل الصديق، أنه مهما طال زمن المعارك، فلا بدّ أن تأتي ساعة الحقيقة والبدء بالحوار من أجل حلّ ما تم تأجيله طيلة فترة القتال.
نقلاً عن موقع وكالة أنباء الحدث