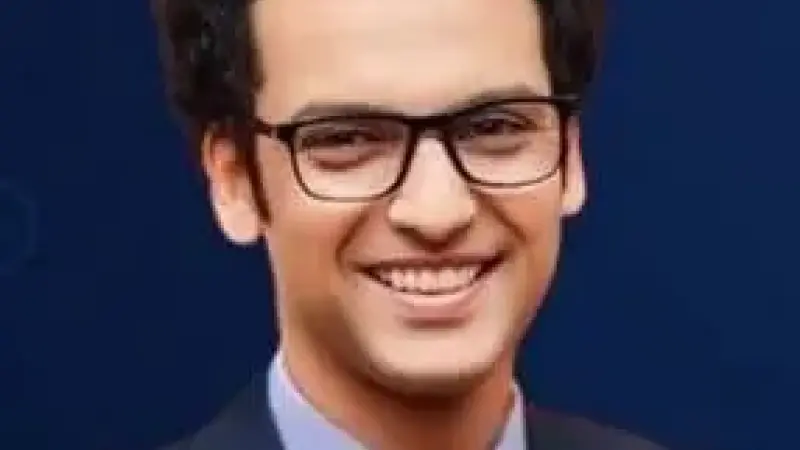
عكفت الفلسفة الحداثية في المرحلة الراهنة للحضارة الانسانية الشاملة على الانفصال عن التراث الانساني بمجمله، وهذا يمثل تصور لبناء حضارة عولمية لا يعني لها التاريخ البشري شيء، رغماً عن ذلك لا مفر من الوقوف أمام هذه الفلسفة نجتر فيها التاريخ الكوني لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها، وذلك في سبيل تعزيز فهمها وفهم جوهر صراع المشروعات المختلفة فوق جغرافيا الشرق الأوسط توحداً كانت أو تفكيكاً.
حول الشرق الأوسط
وكما يرى أوجلان: " بدون فهم هذه الثقافة التي طالما لعبت دوراً محورياً في تاريخ البشرية الكوني، فسيبقى تعريف الفرد لنفسه سطحياً للغاية.. ينبغي الإدراك أنه حتى الثقافة الأوروبية العصرية المهيمنة؛ ما هي في الأساس إلا نسخة مشتقة من ثقافة الشرق الأوسط، وبالرغم من كونها علمياً تشكل مرحلة متقدمة على الثقافة الشرق أوسطية، إلا إن هذه الأخيرة – ثقافة الشرق الأوسط - ما تزال تؤدي دوراً مُعَيِّناً في تقرير مصير الثقافة الأوروبية، وليس عبثاً أن تَخطُرَ هاتان الثقافتان بالبال لدى الحديث في راهننا عن صِدام أو وفاق الثقافات أو الحضارات ".
ومن الواقع التاريخي لم يَعُد الشرق الأوسط مجرد مساحة جغرافية عشوائية، بل بات يُشَكِّل المكان الذي سيُؤدي التاريخ الكوني دوره على مسرحه، حيث يشير أوجلان الى أن: "اقتياتَ التاريخ الكوني، إنما يجعل أهمية المنطقة ومكانتها أكثر لفتاً للأنظار، إذ يتميز الشرق الأوسط بشأن يوازي ما هي عليه أوروبا بأقل تقدير، سواء من حيث حل القضايا العالمية، أو على صعيد التركيبات الحضارية الجديدة ".
ويُعزي اوجلان انتهاء الأنظمة الشرق أوسطية بمجموعاتها وشرائحها الى الفشل سببه شتى أنواع النقل والاقتباس من التاريخ والتي قامت بها – هذه الأنظمة - وفقاً لمصالحِها ومَشارِبِها عن طريق أنشطتها الاستشراقية المُستَورَدة والمُقتَبَسة من المدنية الأوروبية، قد عجزت جميعها عن تكوين تركيبة جديدة أو صياغة نظرية سديدة أو إحراز تطور سياسي حر موفق.
مشروعات الوحدة والهوية العربية
وعن مشروعات الوحدة والهوية العربية وقضايا الثقافة في دول الشرق الوسط فقد تبلورت الوحدة العربية كمشروع جديد متميز كلياً عن مشروع الاستقلال عن السلطنة العثمانية في الحقبة الاولى، وطُرحت الفكرة باعتبارها استراتيجية جديدة ومشروعاً يستطع وحده أن يقدم الى الاقطار العربية المكافحة ضد الاستعمار، ثم المستقلة، ولكنها سرعان ما تعثرت في مضمونها السياسي والاجتماعي حين انهيار الوحدة السورية المصرية، وتفاقم النزاع بين اطراف الحركة القومية العربية بمكوناتها المختلفة، السياسية والقطرية، وفي مقدمة ذلك الصراع بين الجمهورية العربية المتحدة والسلطة الثورية الجديدة في العراق، الحرب العربية – العربية في اليمن، وبتدقيق النظر الى حقيقة القومية والقطرية؛ فالقُطرية العربية تحققت على الارض وفي الوقائع والاعيان، والقومية حلقت في الاذهان والضمائر والكتب والمجلات والقصائد والفنون، الاولى وُجدت كعملية بلا رديف نظري والثانية واصلت وجودها كنظرية بلا رديف عملي في شكل دولة واحدة (البلاد العربية نموذجاً).
وهنا ثمة نوعين من القومية؛ قومية دعوة وطموح خائب، وقومية واقع ووجود محقق، الاولى هي رابطة اللغة وثقافة وفكر (كمثال القومية العربية) لا رابطة دولة واجتماع وسياسة، والثانية قومية الدولة القطرية وهي رابطة موضوعية تضم في تكوينها كلا من اللغة والدين والارض والدولة والتقاليد والطقوس الوطنية.
مشروعات التفكيك
أما فيما يتعلق بمشروعات التفكيك وقضاياه نجد أن مصطلح " الفوضى الخلاقة " دخل القاموس السياسي في العقدين الأخيرين، ويتميز بقدر كبير من الالتباس والتأويل يصل الى حد التحايل والتلاعب اللفظي لوصف حقبة سياسية تاريخية صاخبة.
ويرى أوجلان صناعة الفوضى: " بتَبَعثُر بُنية النظام يتَوَلَّد وسط من الفوضى يلائم ظهور بُنى نظامية جديدة، ومَن يَمتَلِك الأجوبة الأوقع من بين القوى الاجتماعية فيما يتعلق بالاستعدادات الأيديولوجية والبُنيَوِيّة، يكون قد اكتسب فرصة أو وظيفة أداء الدور الرئيسي في بناء وهيكلة النظام الجديد"، ويرافق نظرية الفوضى الخلاقة مفهوم " غزو العقول " الذي يقوم على اساس الرضوخ الداخلي ويلعب ضمن دائرة نقاط الضعف لدى الطرف المستَهَدف، وهذ ما نعته أوجلان بمفهوم " الأسر الذهني " وهو جزء من تصنيع الثقافات الموظَفة في تحقيق ارباح لا تتوقف فقط على الربح المادي بل ارباح اجتماعية كذلك: " فالسلع الثقافية لا تقتصر على تمهيد السبيل لإدرار أرباح طائلة فحسب، بل إنّ وظيفتها المدمرة الأساسية تتمثل في تكريس الأَسْر الذهني بأبعاد لا نظير لها في التاريخ، لتُكَوِّنَ بناء على ذلك الطبقات والأمم والعشائر وشتى المجموعات التي تكون في حالة أسوأ من حال قطيع المواشي ".
من خلال استعراض القضايا التي تمثل صميم الازمات الرئيسية المتعلقة فيه بالطبيعة الاجتماعية؛ يتناول أوجلان أزمة المدنية وحل الحضارة الديموقراطية في الشرق الأوسط ، وقد استهل تناوله في سياق رؤيته المستنيرة بقضية المرأة والتي يتبنى في سياقها تنحّي التعاطي الجنسويِّ المتصلب الذليل، كما ينبغي المعرفة أنه يستحيل عيش حياة ثمينة ذات معنى، ما لم يتحقق عيش سليم مع المرأة ضمن المجتمع "، ويوصي اوجلان بضرورة صياغة الاقوال وتطوير الممارسات انطلاقاً من الإدراك بأنّ الحياة الأثمن والأجمل يمكن تحقيقها مع المرأة الحرة المتمتعة تماماً بكرامتها وعزتها.
قضايا العشيرة والإثنية
أما القضية الثانية ضمن ازمات مجتمع الشرق الأوسط في رؤية أوجلان فتتمثل في قضايا العشيرة والأثنية والقوم، حيث تمثل العشيرة في رؤيته " بنية مجتمعية حقيقة "، لما تمثله من القيم المتبادلة بين الفرد وبين العشيرة الكل - حيث ينحازون لصالح مجموعاتهم عندما تقارن بمجموعة اخرى - وذلك في سياق حياة طبيعية حرة، إلا أن تصاعد المدنية الدولتية كان أكثر سطوة عليها، فتناقضت مبادئ الدولة مع العشيرة فكان لها أثر سيء، مما دفع العشيرة أن ترتقي بشكلها التنظيمي الى مستوى الملة أو القوم، أي التوجه نحو الأمة مما اضاف اليها أيديولوجية تتبعها وتنتظم وفقها، مثال الاديان التوحيدية في الشرق الأوسط، والاديان في الاقوام الاغريقية والارمينية والاشورية والعربية والفارسية والكردية، فقد كانت جميعها تختار حسبما تتوائم مصالحها القومية.
قضية الدين والمذهب
القضية الثالثة قضية الدين والمذهب، في نظرته يرى أوجلان المذهبية الدينية اضيفت بجانب القضايا الدينية، فأصبحت المذهبية ذات قضايا متباينة داخل قضايا الدين الواحد، ووعود الدين بالسلام والاخوة والاتحاد والتكامل هددتها مصالح المادة، وأن المادية في مواجهة القيم الدينية لها تأثير كبير وسطوة فكان التفاوت الطبقي المتنامي في المجتمع، ولم يتوقف ذلك بل وصل الى نشوب النزاعات والحروب، وذلك لم يكن مُحدَث في شأن المذاهب بل منذ عهود الانبياء وعصور الخلفاء، ما بين السنة والشيعة، ويرى ميل الاقوام الى المذاهب حيث المنفعة المادية، ويعزي اجلان الميل للمذهب السني لدى السلاجقة رغبة منهم في السيطرة والانتشار وذلك ما تناسب لديهم في سياق السيطرة والغلبة، ولا تستثنى المسيحية من المذهبية ايضاً فبحث اللاتينيون عن الخلاص عبر المذهب الكاثوليكي، وبحث الإغريق والسلاف كذلك عبر المذهب الارثوزكسي، والارمن عبر الغريغوريانية، والآشوريون عبر النسطورية، اما اليهودية لم تكتفي فقط بإخراج المسيحية والاسلام من صفوفها بل انقسم اليهود على انفسهم، منهم من والى الفرس ومنهم من والى الاغريق، وكذلك الانقسام الى يهود الغرب ويهود الشرق (الاشنازيم والسفارديم).

قضية المدنية والبيئة
لم يغفل أوجلان في السرودات قضية المدنية والبيئة في سياق أزمة الشرق الأوسط ، حيث يعتقد اوجلان منذ العهود السومرية يُشكل التمدن مظهراً رئيسياً من مظاهر التسلط: " فالتمدُّن يَحمِل الاستعباد وبالتالي التدوُّل في خباياه، وتَأَسُّس السوق يجلب معه قضايا اقتصاديةَ أيضاً "، وذلك عن طريق تقرير نسب التبادل والمقايضة – الاسعار - ، كذلك أمر الحماية – الأمن - وتكوّن الجماعات قرينة السلطة المتناحرة فيما بينها (الراهب، الحاكم والقائد العسكري) وصولا الى قضايا التضخم والتوسع، وتعد دولة المدينة اقدم أشكال السلطة، بينما الامبراطوريات والدول القومية ظهرت كانساق جديدة فيما بعد، وكان الصراع بين المدائن يأذن بتكوين المدن المهيمنة مثل بابل آشور أثينا روما، والتي أدت فيما بعد دور مراكز الامبراطورية.
ويرى أوجلان ان على الرغم من كبر مدائن الشرق الاوسط في العهد الاسلامي الا انه لم تكن متقدمة معمارياً عما كان عليه مستوى المعمار في العهد الهيليني، وكذلك لم تنتقل الى ثورة صناعية مما زاد من قضاياها الداخلية وطأة، بينما حمل التمدن في أوروبا ظهور المدن الاقتصادية والاسواق، مما برز فيها رأس المال بما دفع الى بسط النفوذ على شرائح الصناع والحرفيين والريفيين، وغدت الثورة الصناعية ككارثة تأذن بنهاية المدن وتدهورها، فكانت بمثابة السرطان الذي انتهى الى كارثة بيئية، فاضحت المدينة لا تقتل نفسها فحسب بل تقتل البيئة، مستهلكة في ذلك الريف والمجتمع الريفي، ندرك بذلك ان قضية البيئة انها قضية مجتمعية وهذا ما تسبب في الكوارث والقضايا والازمات في منطقة الشرق الاوسط بالرغم من احترام الاديان للنظم الايكولوجية، فالشرق الاوسط يئن تحت وطأة الهيمنة الرأس مالية واستغلال الموارد فهو الاقرب الى التصحر لأسباب جيولوجية طبيعية واصطناعية على السواء، فكأنه يرغم على التخلي عن الحياة.
ويضيف أوجلان الى جملة القضايا المؤثرة في الطبيعة الاجتماعية للشرق الأوسط كل من قضايا الطبقة، الهرمية، الأسرة، السلطة والدولة، فيرى ان مجتمع الشرق الأوسط أسبق المجتمعات في تجذر منظومة الهرمية والتي تأست على الشباب والمرأة، ثم تتمظهر في تحالف الرجل المستبد، الشامان والراهب، الرجال العجائز الخبراء، ويُعد هذا النموذج البِدئيّ في الهرمية والسلطة في التاريخ الكوني ونموذج لكافة الهرميات والذي تصاعدت على إثره السلطات بتوسع نُسُقها.
أهمية تحليل الأسرة
ويربط أوجلان بين اهمية تحليل الاسرة والسلالية ونظمها كأيديولوجية وبنيوية متداخلة وبين السلطة والدولة والهرمية الفوقية: " بأنه النموذج البِدئيُّ للسلطة والدولة، ويَرتَكِزُ إلى دعامة الرجل والأولاد الذكور، فامتلاك عدد كبير من الذكور أمر مهم لأجل السلطة، وقد أفسحت هذه الخاصية المجال أمام تَعَدُّد الزوجات، وأمام حياة الحَريمِ ونظام الجواري".
ويعزو أوجلان منبع السلطة والطبقية والدولة في مدنية الشرق الأوسط بتجذره في واقع السلالة، أي أن أيديولوجية السلالة أنتجت نظام العبودية والاخضاع لدى العشيرة أولاً ثم بقية القبيلة وأحدثت فيها أول تفاوت طبقي، وهذا يختلف عن مضمون الولاء أي حالة الدمج بين الذات الفردية في ذات اوسع منها واشمل ليصبح الفرد بهذا الدمج جزءاً من اسرة او من جماعة او من امة، وبذلك تكون النواة الأولى لإنتاج السلطة والدولة.
ويرى أوجلان أن الحَطّ من شأن المرأة، اللامساواة، وعدم تعليم الأطفال، نزاعات الأسرة وقضية الشرف؛ كلّها مرتبطة بالنزعة العائلية، وكأن نموذجاً مُصغراً من قضايا السلطة والدولة الداخلية قد أُسِّسَ داخل الأسرة، من هنا، فتحليلُ الأسرة شرط لا بد منه لأجل تحليل السلطة– الدولة– الطبقة والمجتمع.
قضايا الأخلاق والسياسة والديمقراطية
وفيما يتعلق بقضايا الأخلاق والسياسة والديمقراطية، يشير أوجلان بانه: " لا وجود للمجتمع من دون الأخلاق والسياسة، ولو تواجدت هكذا مجتمعات، فلا يمكن أن تكون إلا أداة مُسَخَّرة لخدمة مجتمعات أخرى "، فثمة تلاحمية فيما بين الاخلاق والسياسة يوضحها أوجلان: تَقوم الأخلاق بوظيفتها وتؤدي دورها كتقاليد على شكل قوالب معيارية، فإن السياسة تعني كُلِّيَّةَ القرارات المُتَّخَذَة بشأن القضايا التي تواجه المجتمع يومياً، وبقدر ما تتحول كُلِّيَّة هذه القرارات إلى تقاليد، فهذا يدل على التحامها وتَكاملها مع التقاليد الأخلاقية، وتَحَوُّلها بالتالي إلى قواعد أخلاقية بالتحديد".
وفي اشارة الى إزالة الالتباس بين كل من الاخلاق والسياسة يوضح أوجلان أنه لا يمكن أن يَقُوم القانون مقام الأخلاق الحية في أي وقت من الأوقات، هذا ويجب الفهم أنه يستحيل إطلاق تسمية "السياسة" على أي نشاط أو قرار أو تنفيذ معنيٍّ بالشؤون الداخلية والخارجية لحُكم الدولة، قد يُسمى ذلك بسياسة الدولة، ولكن؛ يستحيل تسميته بسياسة المجتمع.. وليست السياسة ظاهرة أو مصطلحاً يتكَوَّن بلا شعب أو بلا مجتمع أو بلا مشاركة، ونظراً لضرورة أن تَكُون السياسة ديمقراطية، فمن الضروري أن تكون أخلاقية أيضاً، ولا يُمكِن لمجتمع أن يَكُون سياسياً في حال غياب الديمقراطية، ولا أن يَكُون أخلاقياً في حال غياب السياسة.
العلاقة بين الأخلاق والسياسة
أما العلاقة بين الأخلاق والسياسة والديمقراطية في مجتمعاتِ الشرقِ الأوسط يرى اوجلان وجود قضايا متعلقة بها بشكل جدي، وهي قضايا شاملةٌ أيضاً بحُكم سياق المدنية، ويفرق هنا بين رؤية الاخلاق والسياسة بين مجتمع الشرق الأوسط والمجتمع الأوروبي: " أنّ قوانين وسياسة وديمقراطية المدنية الأوروبية هي بورجوازية الطابع إلى حد بعيد، وأنها لا تُمَثِّل ظاهرة الأخلاق والسياسة والديمقراطية للمجتمع– التاريخي الكوني ولا تُصَوِّرُها "، ويتضح من ذلك أنها لا تمثل تصور أو نموذج سياسي أخلاقي البته، وما ذلك الا ممارسات برجوازية في أساسها لا تمثل ديموقراطية، حيث تتضح حقيقة الممارسات في المجتمع الأوروبي في أن القوانين والحقوق قد حلَّت محل الأخلاق تماماً – بدون تعميم لديه -، ويرى أوجلان أن ما يمارس في المجتمعات الاوروبية من القوانين: " هي عبارة عن كومة من التعاقُدات المعنية بالدولة والسلطة، ولا يُمكن أن يقوم القانون مقام الأخلاق الحية في أي وقت من الأوقات "، وهنا اشارة الى انه قد تتنافى القوانين مع الاخلاق رغماً عن ممارستها، فهذا لا يعني أنه تمثل قيمة اخلاقية في سياق الاقرار بها في بعض المجتمعات.
وينتهي اوجلان في قضية الاخلاق والسياسة في مجتمع الشرق الأوسط رغماً عن أزمتها الدياليكتيكية إلا أنها تمثل طاقة كامنة، حيث: " ان الطاقة الكامنة للديمقراطية والأخلاق والسياسة قوية في مجتمع الشرق الأوسط، فوجود قضايا الأخلاق والسياسة والديمقراطية الجادة، يشير إلى مدى قوة طاقتها الكامنة أيضاً، وكون ميول الدولة والسلطوية لا تزال قوية، إنما تُذَكِّر في وجهها الآخر بالقضايا الأخلاقية والسياسية والديمقراطية الوطيدة، وبمدى الحاجة الماسة إلى الأخلاق والسياسة والديمقراطية، بل وحتى بمدى وجودها ".
القضايا الاقتصادية والأيديولوجية
وفيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والأيديولوجية في مجتمع الشرق الأوسط، لتفهم طبيعة المشكلات الاقتصادية للشرق الاوسط تناول اوجلان مفهوم الاقتصاد بما خضع لتصور المجتمع الغربي والذي تمأسس عليه الاقتصاد العالمي، وقد أطلق عليه أوجلان " الاقتصاد السياسي " بما فيه رأس المال، والذي تتعلق مواضيعه الاساسية بالربح والأجور المُؤَمَّنة عن طريق الإنتاجِ بموجب الأسواق، وهذا في تصوره ليس علماً، إنما قواعد مضبوطة حسب حياة البورجوازية المُتَأسِّسة تماماً على الربح، فالحياة وفق ذلك تعني السلطة الأكثر وحشية.
تبدأ القضية الاقتصادية أساساً مع تجريد المرأة من الاقتصاد، بالرغم من أداء المرأة دورها في مركز الاقتصاد أمر طبيعي، لأنها تنجب الأطفال وتغذيهم، لقد تَحَوَّل الاقتصاد، إلى كومة من القضايا الإشكالية لدى طرد المرأة منه في تاريخِ المدنية عموماً، وفي الحداثةِ الرأسمالية خصيصاً، لقد طُرِدَ المزارعون بعد المرأة من الساحة الاقتصادية، ثمَّ طُرِدَ الرّعاة والحِرَفِيّون وصغار التجار المَعنِيّون بالاقتصاد الحقيقي خطوة بخطوة على يَدِ أجهزة احتكارات السلطة ورأس المال.
إنه فارق مهمّ يُميِّز مجتمع الشرق الأوسط، ألا وهو تسريب الفوائض الاقتصادية بيَدِ الدولة، فسيُلاحَظ أن الدولة في نهاية المطاف هي الصاحب الشرعي الوحيد للفوائض الاجتماعية، ورؤيتها لنفسها كصاحبة المُلكِ يُعَدُّ سبباً كافياً أصلاً من أجل ذلك، فتاريخ المدنية هو تاريخ اقتصاد مضاد، وكل القضايا الاقتصادية تُعاش نتيجة لهذا التناقض، من هنا، وبقدر ما ترفع الطبقة الحاكمة والمدينة والدولة يدها عن الاقتصاد - بقدر ما يتم تحجيمها وتترك الاقتصاد لأصحابه الحقيقيين - فإن القضايا الاقتصادية ستَلِج درب الحل حينذاك بالمثل، هذا التشخيص الصائب على صعيد الاقتصاد الكوني، إنما هو صحيح زيادة عن الحد لأجل الحياة الاقتصادية أيضاً في الشرق الأوسط.
وفيما يرتبط بالأيديولوجيا يرى أوجلان أنه لا مجتمع بلا أيديولوجيا، كونها قوة الثقافة المعنوية، وظيفتها أساساً هي تنظيم الحياة وإضفاء المعاني عليها، ولقد أدت الأيديولوجيات دوراً عظيماً في حضارات الشرق الأوسط، فقد تحولت الأيديولوجية الميثولوجية إلى أيديولوجيا دينية، ومن ثمَ إلى أيديولوجيا فلسفية، وأخيراً إلى نظريات علمية.
فقضايا الحياة الاقتصادية والاجتماعية تجد المقابل لها في الأيديولوجيا، سواء بشكل حقيقي أم مُحَرَّف، فمؤسسات السلطة والدولة والسلالة تُنشِئ وتُقَدِّم ذاتها على شكل ألوهيات كنموذج مثالي جداً في عالم الأيديولوجيا، فالقضايا والنزاعات القائمة فيما بينها تُعاش كما هي في آثارها أيضاً، بقدر ما يُعَد الميدان الأيديولوجي ضرورياً لأجل فهم حسن للقضايا المادية، فالعكس أيضاً ضروري بالمثل، وبقدر الفصل بين الجانبين والوجهين، فمن الضرورة بمكان البحث دائماً عن الروابط التي بينهما أيضاً.
فالقضايا الاجتماعية المتفاقمة تُصَيَّر قضايا أيديولوجية في هذا الاتجاه، ربما الأمر كذلك بدافع من الإيمان بإمكانية حلها هكذا بسهولة أكبر، فانتعاش الأيديولوجية الإسلامية يَعكِس حضور القضايا الاجتماعية المتزايد، أما عجز أيديولوجيات الحداثة عن التحول إلى أداة حل، فينبع من عجزها عن تشكيل الأواصر الواقعية مع القضايا الاجتماعية، كما أن الفشل في الأيديولوجيات، سواء التقليدية منها (الدينية) أم الحداثوية (الليبرالية، القوموية، الاشتراكية وغيرها)، معنيٌّ بعدم عكسها السليم للقضايا الاجتماعية، بالتالي، فالحل بنَمَطَيه التَّطَوُّرِي التدريجي والثوري يفرض عيش الصواب، قولاً كان أم عملاً.
الثورة في الشرق الأوسط
وفيما يتعلق بقضية الثورة في مجتمع الشرق الأوسط؛ يفسر أوجلان تاريخ المدنية الشرق اوسطية على أنه تاريخ الثورة المضادة تجاه كل من المرأة، الشبيبة، مجتمع الزراعة – القرية، القبائل والعشائر المستقرة والرحالة، أصحاب المذاهب والعقائد الباطنية وكل من يراد استعبادهم، وكل المطرودين من نُظم المدنية، والسبب في ذلك كونها نظاماً نفعياً ذاتياً.
وعليه؛ يٌعرّف أوجلان الثورة بانها: " تعني إعادة اكتساب المجتمع الأخلاقي والسياسي والديمقراطي لماهياته تلك مجدَداً وبمستوى أرقى، بعدما حَدَّ نظام المدنية من مساحتِه وأعاق تطبيقَه على الدوام ".
فثمة عدم وجود فوارق جوهرية بين العديد من الايديولوجيات ما دامت المجتمعات تخلو من طباع أخلاقية وسياسية وديمقراطية تتسم بمزيد من فرص عيش الحرية والمساواة، وفي هذا السياق يضرب اوجلان مثلاً: " قد أُدرِكَ بعد انهيار السوفييت بما فيه الكفاية أنه ما من فارق جذري بين الإنسان الاشتراكي في روسيا الاتحادية والإنسان الليبرالي في أوروبا، كما أن الفوارق النابعة من الدين بين مسيحي ومسلم هي ذات تأثير جزئي منخفض جداً على حياتِهم "، فجوهر الفوارق بين كل هذه الايديولوجيات تتحدد بالظواهر التي تنعكس على المجتمع حين ممارسات مفاهيمها محققة بذلك الحرية والمساواة.
وفي صياغة تقريرية مختزلة لتفسير واقعي لمجتمع الشرق الأوسط يطرحها اوجلان أنه: " لن تكون ثمة صعوبة تُذكَر في تشخيص الماهيات الأخلاقية والسياسية والديمقراطية للثورة التي يجب إنجازها، إذ يمكن من خلال الأحداث الجارية الإدراك جيداً أن كل الأيديولوجيات التقليدية والحداثوية المُجَرَّبة قد جَعَلَت الوضع أكثر إشكالية ".
..... نقلاً عن مجلة الأمة الديمقراطية
من زوايا العالم